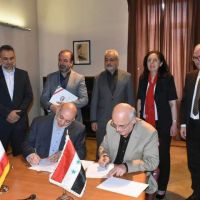من مذكرات مدرِّسة (3)
ماري عربش
أشجار شيكاغو المتباهية بمساحات امتدادها ورونق اخضرارها، تحلق في فضاء الخيال لوحات تبهر النظر. كيف تحوّلت خوابي الخمر الفخاريّة إلى خوابٍ زجاجية شفّافة عالية؟ نبتت على ضفاف الطرقات تتوهّج كألسنة اللهب، وكيف تناسقت أمامها مزهريات تمازجت فيها كلّ الألوان؟ وكيف تحوّل هنا اللون الأصفر ذهباً يشعّ كخيوط الشمس؟ يا الهي من رسم كلّ ذلك الإبداع الساحر؟
وبينما كانت متعة النظر تغمرني تلمّست ارتعاشة في انحناءات روحي ومسامات وجداني، وانتفضت نبضات قلبي. إنّها اهتزازات جذور أشجار بلادي التي حفرت عميقاً في أبعاد نفسي، ورأيتها متناثرة متباعدة مبعثرة، لكنّها راسخة هنا في كياني.
كتبت هذه الكلمات أمام أول خريف تشهده عيناي في هذه المدينة وكان عام 2011 (لقد أعدتني يا آنسة خمسة وعشرين عاماً إلى الوراء، إلى مقعد الدراسة في هاتيك الثانوية، وها أنا أراك أمام عينيّ في تلك الحصّة الصباحية وقد حبست دموعك وغصصت بها وأنت تنقلين إلينا مشاعرك عندما سمعت الأذان وأنت في البرازيل، لم ولن أنسى ذلك الموقف)، إنّه تعليق عمَّار الذي كان أحد طلابي ويعيش اليوم في برلين، وها أنا مرّة ثانية في ذلك الصف، وفِي الحصة الأولى، ومع الدرس الأول من أدب المهجر.
أذكر تماماً كيف وقفت صامتة وعيون الطلاب ترقب ارتباكي غير المعهود لديهم، افتح الكتاب وأسرع في إغلاقه، أهمّ بالكتابة على السبورة وأتراجع، وسؤال ملحّ في ذهني، تُرى هل سأتمكّن من نقل كلّ كثافة هذه المشاعر التي أعيشها مع أدب المهجر إلى نفوس طلبتي؟ من أين سأبدأ؟ أمن قراءة التمهيد الذي كُتب كمدخل لهذا الأدب؟ أم من التعريف بأدبائه؟ أم بإلقاء أول قصيدة؟ وكانت للشاعر شفيق معلوف، لمَ كلّ هذا التردّد؟ أنا التي عهدتني أبحر في عمق تلك القصائد وأفتّق معانيها، وأعيد رسم صورها، وأستمتع بشرح تفاصيلها، مستمدّة كل ذلك من مخزون المشاهد التي عشتها طفلة صغيرة وفتاة يافعة، لم يكن بيت من بيوت بلدتي يبرود ليسلم من هجرة واحدٍ أو أكثر من أبنائه إلى الأمريكيتين بعد أحداث الثورة السورية الكبرى -لن أقحم الحديث عن هذه الثورة في ذكراي اليوم ربما سأعود إليها في ذكرى لاحقة- لقد عشنا هموم الغربة وابتعاد الأهل عنّا، لقد هاجر كل أعمامي وعماتي، وكل أخوالي وخالاتي وحتى جدتي لأمي.
ولأننا كنّا خمسة ومعنا جدي وجدتي لم يتمكن والداي من الهجرة. وما فتئت أتذكّر حداء أمي للطفل الصغير وهي تهز السرير المزركش ودموعها تنهمر: يا حادي العيس سلملي على أمي...يا حادي العيس سلملي... وسلملي.
شجون كثيرة تغلغلت في قلوبنا الصغيرة ونحن نسمع أخبار المهاجرين وقصصهم والصعوبات التي تحملوها في رحلاتهم وبعد وصولهم إلى بلاد لا يعرفون فيها أحداً. ولم تكن وسائل التواصل معهم إِلَّا الرسائل التي قد تستغرق شهراً أو أكثر في رحلتها وقد تضيع في الطريق.
أتذكّر كيف كنّا نتحلّق حول والدي وهو يقرأ الرسالة بصوت مرتفع متهدّج وأمي تذرف الدمع بصمت، وكانت كل الرسائل تنتهي بكلمات وداع تُشعر أنه الوداع الأخير. ولم يكن أولئك المهاجرون ليتمكنوا من زيارة الأهل في الوطن إِلَّا بعد انقضاء سنوات وسنوات قد تصل إلى العشرين والثلاثين والأربعين، وكان نبأ وصول أحدهم إلى البلدة ينتقل من بيت لآخر بسرعة النار في الهشيم. قد تنبت له أقدام فيقفز فوق الجدران المتواضعة التي تفصل بين البيوت، وقد ينفلت من فم جارة تنشر الغسيل على سطح الدار ليصل إلى مسامع أخرى تحرّك القمح المسلوق المنشور على سطح بيتها، ويتوافد أهل البلدة وحدانا وزرافات للسلام على ذلك المغترب، والسؤال عن أقاربه غير مقدرين بعد المسافات المترامية فيما بينهم، وأذكر تماماً حين جاءت عمتي إلينا في بيتنا الكبير الفسيح وكان بيت العائلة، بعد غياب دام ثلاثة وأربعين عاماً، أذكر كيف راحت تسأل بلهفة تملكت كل جوارحها عن -الفروة- التي كانت تضعها قرب فراشها، وكيف أكّدت أنها وضعتها قبل سفرها هنا في الطاقة المحفورة في الجدار ووضعت فوقها منديلها الخمري المبرقع، وأمّا عن قصص العذاب وروايات الشقاء فحدّث ولا حرج، فهذا الذي بات ليالي طويلة في العراء، وذاك مثلها في الغابات، وآخر على مقاعد في محطات القطار.
كل هذه الصور كانت تتدفّق في ذاكرتي عندما أبدأ كل عام بهذا القسم من كتاب الأدب الحديث للصف الثالث الثانوي والمسمى أدب المهجر، لكنّ هذه الحصة التي أعادني إليها عمار كانت الأولى لي بعد زيارتي التي استمرت ستة أشهر للبرازيل، حيث عائلتي الكبيرة وقد التحقت بها مؤخّرا أختي وعائلتها، هنا رأيت بأم عيني بعض أدباء المهجر وتحدّثت إليهم ومنهم الشاعر القروي الذي سنشرح قصيدة له، سمعت منهم ما قد سمعته ممن زار الوطن من المغتربين، وما لم أسمعه من أحد قبلهم.
وَيَا لقسوة ما سمعت وما رأيت، لذلك وقفت في هذه الحصة وقفة مختلفة، وقفة من عاين عن كثب ومن سمع تأوهات المغتربين وأصغى إلى ضجيج قلوبهم التي لم تغادر الوطن يوماً. لقد رحلوا بأجسادهم وهنا تَرَكُوا قلوبهم في الدور والحقول، في الأزقة والدروب، هنا في ملاعب الطفولة والصبا، هنا في بيادر القمح، وفِي كروم العنب والتين، هنا في ظلال أشجار الجوز والخوخ والتفاح والمشمش.
في تلك الحصة وبعد صمتي وحيرتي لدقائق معدودة قلت للطلاب: ضعوا الكتب داخل مقاعدكم، سأروي لكم في هذه الحصة بعض القصص التي سمعتها من أدباء المهجر وبعض الأحداث مرّت بي، والتمعت عيونهم وتحوّلوا إلى آذان صاغية، وبدأت بالحديث عن الشاعر القروي الذي شرح لي معنى (الكشّة) التي حملها طويلاً كغيره من المغتربين، وطاف بها في الأرياف البعيدة ليكسب رزقه من بيع ماتتسع له من حاجيات صغيرة، وهي الصندوق الخشبي المربّع الشكل المكشوف من الأعلى والذي يحمل على الظهر بواسطة حبلين يشدانه إلى الكتفين.
كثيرة هي القصص التي رويتها في تلك الحصة قبل أن أصل إلى ما استقرّ في ذاكرة عمَّار، كنت مع أختي نستمع إلى الأخبار، ولم تكن خدمة اللغة العربيّة متوفّرة في ذلك الوقت لوسائل الإعلام، اللغة برتغالية لكنّ المشهد انتفاضة الأقصى الأولى، وصادف موعد آذان المغرب عند عرض المشهد
وما إن سمعنا الله اكبر حتى التقت عيوننا وقد فاضت بالدموع، ولمّا رويت هذا في الصف عشت اللحظات ذاتها بعمق مشاعرها ودفق إحساسها فانتقلت الى مشاعر الطلاب، وأجدني اليوم وأنا أكتب هذه الذكرى أقول لنفسي: عرفنا صرخة الله أكبر تفتح أبواب الأمل والرجاء، وترفعنا إلى السماء، فمن سخّرها في وطني اليوم للذبح والتدمير والبغاء؟؟؟!!!!